- العلم أصل كل خير، الجهل أصل كل شر " الإمام علي (ع)"
عيد الغدير في ظلاله التربوية الإنسانية
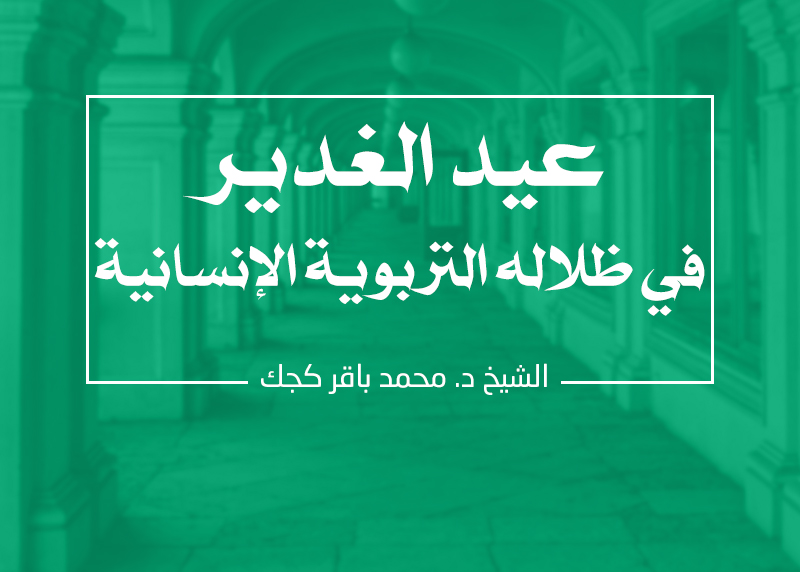
عيد الغدير في ظلاله التربوية الإنسانية
الشيخ د. باقر كجك[1]
نهتمُّ كتربويين وخبراء في التربية، بالمظلّة القيمية التي تنتظم وفقها كافة عمليات التربية، وتسير تحتها في تنظيم البنية التربوية عند الإنسان، ويرتبط بها سلوكه الفردي والاجتماعي بكافة أنواعه السياسي منه والاقتصادي وغير ذلك. إن الاتكاء على الايديولوجيا التربوية، في استخراج المظلة القيمية، هو عملٌ جادٌّ ورصين، ولا يمكنُ التخلّص منه في العمل التربوي، مهما كانت المرجعيات البديلة حيثُ سيكون البديل مهما كان، أيديولوجياً بطبيعة الحال.
ومن هنا، نقفُ بين يديّ مفهوم عقدي وتاريخي، مرتبط بثقافتنا الإسلامية العامة والمنتمية إلى مدرسة أهل البيت(ع)، وأقصد به ذكرى عيد الغدير الأغرّ، كمنعطف عقدي وأيديولوجي هام جداً، أُريدَ له أن يكون أمراً بنيوياً مؤسّساً في رؤيتنا الدينية والقيمية والتربوية.
ولذلك، سنقف أمام عدد من النقاط التي يمكن الإضاءة عليها لتكون بين يدي المربّين:
أولاً: السياق الإنساني-الديني لعيد الغدير
لقد ذكرت كتبُ السِّير والتواريخ والحديث، حادثة عيد الغدير بشكلٍ مفصلٍ ودقيقٍ، بحيثُ لا يستطيع المنصفُ إلا وأن يذعن بثبوت هذه الحادثة، وإرادة الرسول الأعظم(ص) أن يضع فيها مرتكزات وحيانية تأسيسية، خصوصاً في الشق المتعلّق بالولاية من بعده، سلام الله عليه. وهذا التأسيسُ لمنطق الحكم السياسي-الديني، في حادثة الغدير، قد تمَّ تقريره بثلاثة أنواع من التّقريرات:
- أولاً: النص القرآني، حيث نزلت آيات من قبيل (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا[2]).
- ثانياً، النّص النبوي الشريف بألفاظ متواترة لفظيا ومعنوياً من قبيل ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، عن البراء بن عازب، قال: كنا مع رسول الله (ص) في سفر فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكُسح لرسول الله (ص) تحت شجرتين فصلى الظهر و اخذ بيد علي (ع) فقال: " ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم" ؟ قالوا: بلى . قال: "ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه"؟ قالوا بلى . فاخذ بيد علي فقال: "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ من والاه و عادِ من عاداه". فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة"[3]، وقد روي هذا الحديث وأشباهه عبر طرق بلغت 110 صحابيا فضلاً عن التابعين والمحدّثين، ناهيك عن المروي في كتب الشيعة بطرقهم عن أئمتهم العظام سلام الله عليهم.
- ثالثاً: التقرير، أي فعل الرسول الأعظم(ص) في تلك الحادثة، حيث أصرّ على جعل الإمام إلى جانبه، ورفعه ليده، أمام الناس، ثم نصب خيمة للورود إليه والتهنئة والتبريك له والمبايعة.
هذه الطرق الثلاثة، هي أساسُ فهمنا وبحثنا، في الجانب العقدي والقيمي الذي نرومه. ومن هنا، نشير إلى أن القرآن الكريم، في خصوص هذه الحادثة الجليلة، قد أكّد على أنها تشكّل القيمةَ النهائية والخاتمة المضافة في إكمال "الدين". وبالتالي، ونحن نعلم أن "الدين عند الله الإسلام"، وأن الإسلام هو التراكم الوحياني السماوي النازل على الأنبياء العظام وصولاً إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنَّ صيغة "أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، تنبئ عن كون الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، كان يراد لها أن تكون التتمة النهائية لهذا المسار التاريخي العظيم والمتراكم لخط الأنبياء عليهم السلام، بما يحمله من عقائد، وقيم، وأخلاق، وأحكام ناظمة للحياة الإنسانية، ومجمل التراث السّلوكي والتُّربوي لخط الأنبياء.
وبالتالي، فإنّ من المهم هنا، أن نلتفت كتربويين، إلى أن نفهم عيد الغدير، كحادثة إنسانية عظيمة، تفوقَ الجانب المذهبي الضيّق، بل ينبغي قراءة شخصية الإمام علي(ع) كشخصية جامعة لأهم السمات الشخصية والسلوكية والقيمية والتربوية للأنبياء عليهم السلام، وأنّ الكمال الإنساني على مستوى تربية الإنسان، لا تتحقق –إذن- إلا بالتمثّل الصادق والكامل والاقتداء المستدام بشخصية علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد ورد في الروايات عندنا الاشارات الكثيرة إلى مجمع الصفات النبوية التي تمتلكها شخصية الإمام علي عليه السلام، ومنها ما ذكره الذهبي عن ابن عباس: "من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في قربه، وإلى عيسى في زهده، وإلى محمّد في رأيه، وإلى جبريل في أمانته، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب"[4]. وما ورد كذلك عن أبي ذر الغفاري قال: "بينما ذات يوم من الأيام بين يدي رسول الله(ص) إذ قام وركع وسجد شكرا لله تعالى، ثم قال: يا جندب من أراد أن ينظرَ إلى آدم في علمه، وإلى نوحٍ في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره وبلائه ، فلينظر إلى هذا الرجل المقابل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدريّ، أشجعُ الناس قلبا وأسخى الناس كفًّا... قال: فالتفتَ الناس ينظرون من هذا المقبل، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام"[5].
يفتح لنا هذا النوع من التأمل، البابَ الواسع، في تقديم شخصية الإمام علي(ع)، للمتربّين مهما كان لونهم وانتماؤهم، كشخصية رسالية إلهية جامعة لمسار الأنبياء العظام عليهم السلام، وهو ما يسهم أكثر فأكثر في حذف الحساسيات الطائفية والمذهبية الباطلة التي يراد لها أن تحجّم هذه الشخصية الاستثنائية، التي ربط القرآن بين وجودها، وبين اكتمال الدين وإتمام النعمة وتتويج الإسلام كدين نهائي للبشر.
ثانياً: التربية على الارتباط بالقائد الأصلح
تؤكد حادثة الغدير، وعلى الرغم من الكثير من الآراء المتطرفة لبعض الباحثين في نفي الصبغة السياسية في عمل الرسول الأعظم(ص) وأنه لم يكن يريد دمج الدين بالسياسة وغير ذلك، على أنّ الرسول(ص) قامَ بأكثر فعلٍ له دلالة سياسيةٌ في عالم الإيمان، وهو أخذ إقرارٍ من الناسِ بتنازلهم الطوعي والاختياري عن ولايتهم على أنفسهم (أي سلطتهم على أنفسهم) للرسول الأعظم(ص)، ونحن نعلم أنّ هذا الأمر في علوم القانون والسياسة، يعني وضع كل اختيارات الانسان وقدراته وما يملكه من الجسد وشؤونه إلى باقي التصرفات والقوى المعنوية والفكرية، في يد جهة أخرى، كلّا أو جزءاً، يعني الترك لهذه الجهة القرار في الإدارة والتصرف بحسب الغايات والأهداف والقيم التي تؤمن بها هذه الجهة. وهذا هو ما تقوم به السياسة بالضبط. ولذلك، فإن الرسول(ص) بأخذه إقراراً من الناس بكونه جهة الولاية عليهم، ومن ثم نقله لهذه الولاية لعلي بن أبي طالب(ع)، فإنّه قامَ بعملٍ سياسي-ديني تأسيسيّ، في دفع الحكومة الدينية إلى أفق زمني متطاول ومتداوم! وهذا هو بالضبط ما نفهمه من حركة الدين في المجتمع الانساني، والذي من مهامه أن يستفيد من السُّلطة المعطاة له، من أجل وضع السياسات والأهداف والقيم التربوية المناسبة، وتنفيذها عبر الأجهزة ذات الصلة.
في الخلاصة، قدمت حادثة الغدير، التصوّر النبوي الأخير والنهائي، حول فكرة الحكومة الإسلامية، وأنها ترتبطُ بشخصية عظيمةٍ منتخبة من قبل الله تعالى بدليل (اليوم أكملتُ) ونسبة الضمير ظاهرة إلى الله تعالى، وكونه متجلياً في شخص علي(ع).
إذن، نؤكد هنا، على المربّين في هذا القرن الواحد والعشرين، الغارق في صراع محتدم على نظريات السلطة السياسية، وأنواع المعرفة الايديولوجية الملائمة للإنسان، بين اتجاهات علمانية وإلحادية متطرفة، واتجاهات دينية أناركية –غير سياسية- متطرفة، وبين اتجاهات سلفية متشددة، وغير ذلك... أن يقوموا بتحديد موقفهم المعرفيّ السياسيّ، إذ أنّه سيؤثر مباشرة في فهمهم لموقع القيادة للمجتمع، ومن ثم ينفتح البحث إلى تحديد شخصية القائد، وسماته، وأهدافه، وكذلك النماذج المقابلة له ومخططاتهم العملية والعلمية. أؤكد هنا، على أهمية هذا البحث، لأنّنا رأينا كيف أنّ القيادة العلمانية للعالم المعاصر، لم تقتصر فقط على أذية الشعوب المختلفة في ما يخص شأن الحكم والسلطة، بل إنها فرضت عليها نماذج معرفية مضللة ومنحازة وإلغائية، بقوّة السياسة.
لذلك، لا محيص لنا كمربين، إلا أنْ نفهم التربيةَ كذلك في بعدها السياسي، وارتباطها بشخصية القائد، بشرط أن يكون صالحاً بل الأصلح.
لقد كان المخطط الالهي، قائماً على وجود شخصية قيادية استثنائية كشخصية علي عليه السلام، التي من شان سماتها وصفاتها الشخصية أن تُكمل الدين ووتم النعمة! ولنا أن نتصور حجم الضرر الكبير الذي نتج عن عدم العمل بهذه الوصية الربانية من قبل المسلمين عقب وفاة الرسول الأعظم(ص)، وتحويلهم الحكم السياسي-الديني إلى شخصياتٍ أخرى.
ثالثاً: استخراج صفات عليّ(ع) كنموذجٍ تربوي
يفتحُ الغدير، باب الاقتداء الكامل بعلي(ع). إذ أننا نجدُ في حديث الغدير المنقول سابقا، وغيره كذلك، ذلك التأكيد النبوي، على ضرورة الولاء لعلي كالولاء لرسول الله(ص). يحتل مبحث الاقتداء في التربية مكاناً هاماً جداً، خصوصا في المراحل العمرية إلى سنّ البلوغ، حيث تتكامل شخصية المتربي، بحسب المدخلات الحسية والخيالية والمعرفية التي تقدم له. ومن أهمّها، تقديم شخصية قدوة له، بأكثر من طريقة وأسلوب، مضافاً له استخدام الخيال التربوي في تقديم تصورات أكثر دقة وصحة عن شخصية الإمام علي(ع)، والتركيز على تقديم نماذج من شخصيات تتمثّل سلوك الإمام علي(ع) بأكبر قدر ممكن من القرب له، كالعلماء العظام والمربّين الأخلاقيين الاستثنائيين.
نحتاجُ أن نعيد النّظرَ، في كيفية تقديم هذه الشخصية العظيمة، للأطفال والنشء، خصوصاً أنّنا نؤمن بكون الإمام علي عليه السلام قد تعرّض بعد وفاة الرسول(ص)، لحوادث قاسية منعت منْ إكمال الدين كما كان ينبغي، بلْ إنَّ تغييب الإمام علي عن المشهد السياسي لعشرات السنين، أثّر كثيراً على قدرة المؤمنين بالإسلام على الاستفادة من هذه الشخصية، لأنّه أقصيَ عن مركز القرار السياسي ونحن قدّمنا قبل قليل أهمية الارتباط بين المنصب السياسي والأثر التربوي الذي يمكن أن يقدّمه إلى المجتمع. وعلى الرغم من ذلك، يبقى الثراء الكبير الذي تكتنزه شخصية الإمام علي (ع)، في حياته أبان حياة رسول الله(ص)، وبعد شهادته، ومن ثم في ظل الخلفاء، ومن بعدها مستقلا في الادارة والحكم لعدد من السنين، تكفي لتقديم نموذجٍ تربوي استثنائي ولا مثيل له عبر التاريخ، تجمع في أحنائها العلم والمعرفة، والقيادة الاستثنائية، والقيم الإلهية، والشّجاعة منقطعة النظير، والسلوك النبوي المعصوم في إدارة المجتمع، وغير ذلك.
يقول السيد القائد حفظه الله عن خصوصية موقع الإمامة والقيادة الأصلح، على أنها: "تلك القمة في المعنى المنشود من إدارة المجتمع قبال ضروب وأصناف الإدارة المنبثقة عن مكامن الضعف والشهوة والحمية في الإنسان ومطامعه، والإسلام يطرح أمام البشرية نهج الإمامة ووصفتها؛ أي ذلك الإنسان الطافح قلبه بفيض الهداية الإلهية، العارف بعلوم الدين المتميز بفهمه ــ أي يجيد تشخيص الطريق الصحيح ــ ذو قوة في عمله (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) ولا وزن لديه لنفسه ورغباته الشخصية، لكن أرواح الناس وحياتهم وسعادتهم تمثل أهم ما لديه، وهذا ما عبّر عنه أمير المؤمنين عملياً أثناء حكمه الذي استمر أقل من خمس سنوات، فإنكم تلاحظون أن فترة ما يقل من خمسة أعوام هي فترة حكم أمير المؤمنين تمثل أنموذجاً ومقتدىً لن تنساه البشرية أبداً، وستبقى خالدة وضاءة قروناً متطاولة، وهذه هي ثمرة واقعة الغدير والدرس والمغزى والتفسير المستقى منها"[6]، ثمَّ يؤكّد فيقول:
"لو كانت الأمة الإسلامية قد وعت يومها عملية التنصيب التي بادر إليها النَّبي(ص) بمغزاها الحقيقي وأحسنت استيعابها واقتفت أثر عليّ بن أبي طالب (ع) وتواصلت التَّربية النَّبوية، وظلّل المعصومون من بعد أمير المؤمنين (ع) الأجيال البشرية المتعاقبة بظلال تربيتهم الإلهية بعيداً عن الهفوات كما صنع رسول الله(ص)، لأفلحت البشرية في بلوغ المستوى الذي عجزت عن بلوغه لحد الآن بسرعة فائقة، من تطور في العلم البشري وتسام ٍفي المراتب الرُّوحية للإنسان، واستتباب للسلام والوئام بين الناس، وزوال للظُّلم والجور وانعدام الأمن والتَّمييز والحيف بين الناس، وهذا ما صرّحت به فاطمة الزّهراء(ع) ــ التي كانت أعرف أهل زمانها بمنزلة النبي وأمير المؤمنين(ع) ــ من أن الناس لو اتبعوا علياً لسلك بهم هذا الطريق وبلغ بهم هذا المآل. غير أن الإنسان كثيراً ما يقع في الأخطاء"[7].
[1] أستاذ جامعي، باحث في مركز الأبحاث والدراسات التربوية، بيروت.
[2] المائدة، الآية 3.
[3] مسند احمد بن حنبل، ج4، ص 281 ، 1991، دار صادر، ط1، بيروت.
[4] الذهبي، ميزان الاعتدال، ج4، ص99.
[5] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج٣٩، ص٣٨.
[6] إنسان بعمر 250 سنة: لإرساء قواعد الدّين الإسلامي، ص55.
[7] كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ: 18 ذي الحجة 1421ﻫ ق، 14/3/2001م.
أضيف بتاريخ :2024/06/25 - عدد قراءات المقال : 211








 موقع وزارة التربية و التعليم في لبنان
موقع وزارة التربية و التعليم في لبنان